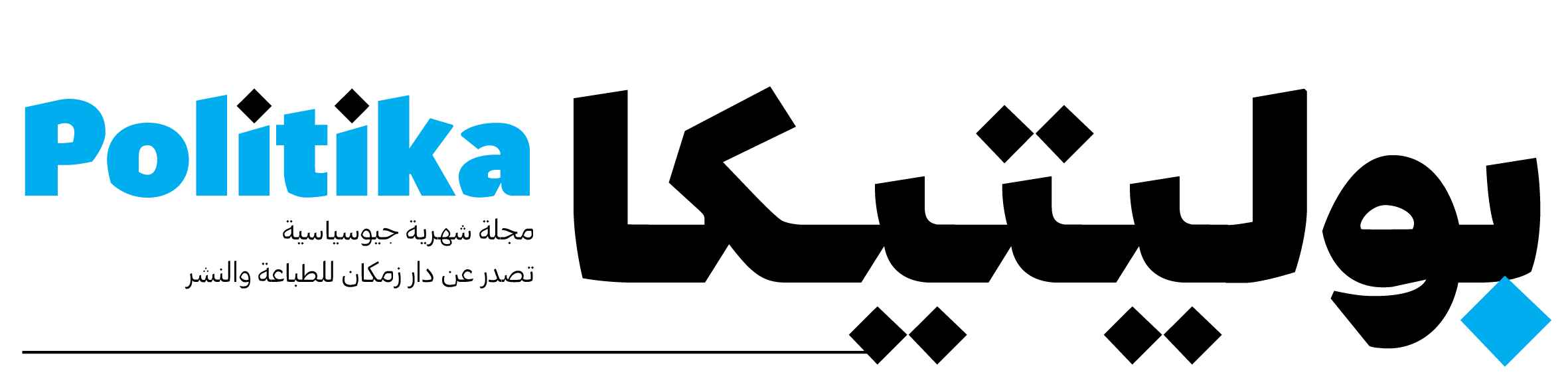عن الفرق بين محامي أمريكا ومهندسي الصين: قراءة في كتاب “على سرعة البرق: سعيُ الصين لهندسة المستقبل”
في السعي إلى فهم الشرق والغرب يُستحسن الابتعاد عن التصنيف المسبق، إذ في ظل التغيرات العالمية التي تحدث اليوم لا بدّ من إعادة تشكيل الفهم بناء على الحقائق لا على الأيديولوجيا، وهو ما عمل عليه “دان وانغ” في كتابه “على سرعة البرق: سعيُ الصين لهندسة المستقبل” أو في اللغة الإنجليزية “Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future”، فقد تحدث عن نظرته ككاتب ومحلل عاش في البلدين، وعمل على استخلاص آليات التفكير. فيما يلي مراجعة لبعض ما ورد
في الكتاب:
حياة الكاتب
« دان وانغ” كاتب ومحلّل تكنولوجي صيني–كندي، يُعد اليوم من أبرز الأصوات في تحليل الصين الحديثة. وُلد في الصين، ثم هاجر مع والديه إلى كندا عندما كان طفلًا صغيرًا. نشأ في بيئة غربية وتلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، حيث درس في نيويورك قبل أن يعمل في وادي السيليكون في مجال التكنولوجيا. بعد سنوات من عيشه في أميركا، قرر العودة إلى الصين عام 2017 ليعيش فيها عن قرب، ويفهم مسارها التكنولوجي والصناعي من الداخل. أقام في هونغ كونغ، ثم بكين، ثم شنغهاي، وتنقّل في مدن صينية صغيرة ومتوسطة، مما منحه منظورًا فريدًا عن الحياة اليومية والتطور الاقتصادي في الصين.
عمل محلّلًا للتكنولوجيا في شركة Gavekal Dragonomics، وهي مؤسسة أبحاث تستهدف المستثمرين العالميين، وكتب خلالها مذكرات وتحليلات معمّقة تُعد من أهم ما كُتب عن التكنولوجيا والسياسة الصناعية في الصين. اكتسب شهرة واسعة بفضل رسائله السنوية التي تجمع بين التجربة الشخصية والرؤية الأكاديمية.
يقدّم “دان وانغ” في كتبه مزيجًا بين فهمه لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما قد يُشكّل محاولة في فهم العلاقات الصينية–الأميركية، والسياسة الصناعية، وتحولات الدولة الصينية. يقول في كتابه :
« هاجرتُ أنا ووالدي من الصين إلى كندا عندما كنت في السابعة من عمري. وفي المرحلة الثانوية، انتقلنا إلى ضواحي فيلادلفيا الهادئة والممتدة بالخضرة، حيث لا يزال والداي يعيشان حتى اليوم. وبعد سنوات، توجّهت إلى نيويورك للدراسة الجامعية، ثم إلى وادي السيليكون للعمل، قبل أن أقرر العودة إلى الصين لأتابع عن قرب تحوّلاتها المتسارعة في مجال التكنولوجيا. وهناك أدركت حقيقة جوهرية: هذا البلد لا يتوقف عن الحركة ».
يُكمل قائلا: “كانت إقامتي في هونغ كونغ، ثم بكين، ثم شنغهاي، بمثابة تجربة تعليمية كاملة ليس فقط لأنها المدن الأكثر ازدهارًا في الصين، بل لأنها أفسحت لي المجال على مدى ست سنوات لمعايشة لحظة استثنائية من الديناميكية الاقتصادية السريعة، والتي ما لبثت أن تحوّلت تدريجيًا إلى حالة من الكبت السياسي المتصاعد”، وحين غادرت وادي السيليكون متجهًا إلى الصين في عام 2017، كان واضحًا بالنسبة لي أن الولايات المتحدة فقدت شيئًا أساسيًا خلال العقود الأربعة الماضية. فبينما كانت الصين تبني المستقبل على الأرض، كانت أمريكا تتصلّب ماديًا شيئًا فشيئًا، وتتركز ابتكاراتها في العوالم الافتراضية والمالية ».
يُضيف: “عبر النظر إلى البلدين جنبًا إلى جنب، أدركت محدودية التصنيفات التقليدية التي ورثناها من القرن العشرين: “رأسمالي”، “اشتراكي”، أو وربما الأسوأ “نيوليبرالي”. فهذه المفاهيم لم تعد قادرة على تفسير الواقع الجديد أو استيعاب التعقيدات التي باتت تشكّل جوهر التجربة الاقتصادية والسياسية المعاصرة. »
أمريكا والصين
صُنّفت العلاقة بين الصين وأمريكا على أنها من العلاقات الحاسمة على الصعيد الدولي، وفي هذا الإطار يقول الكاتب ما يلي :
« السؤال الأهم في عصرنا هو ما إذا كان بالإمكان إبقاء العداوة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة ضمن حدود قابلة للسيطرة؛ إذ إن خروجها عن السيطرة لن يُلحق الضرر بالدولتين فحسب، بل قد يجرّ العالم بأسره إلى كارثة. وأفضل وسيلة لتفادي هذا السيناريو، في تقديري، هي تعزيز الفضول المتبادل: فكلما ازداد الأمريكيون فهمًا للصينيين، وازداد الصينيون فهمًا للأمريكيين، ازدادت فرص تجنّبنا للأسوأ ».
تكمن أبرز نقاط التباين بين البلدين في طبيعة المنافسة التي ستُعرّف القرن الحادي والعشرين: نخبة أمريكية يغلب عليها الطابع القانوني، تتقن فن «العرقلة» وصناعة القيود، في مقابل طبقة تكنوقراطية صينية يغلب عليها الطابع الهندسي، تتقن فن البناء وتسريع الإنجاز. وهذه الفكرة تشكّل جوهر هذا الكتاب: لقد آن الأوان لأن نتبنى عدسة جديدة لفهم القوتين العظميين؛ فالصين دولة هندسية تبني مشروعات عملاقة بسرعة مذهلة، بينما تحوّلت الولايات المتحدة إلى مجتمع قانوني يميل إلى تعطيل كل ما يمكن تعطيله، سواء كان ذلك إيجابيًا أم سلبيًا. ورغم الخلافات الجذرية بينهما، يشترك البلدان في تيار قوي من المادية يتخذ أحيانًا صورًا فجة: تمجيد مفرط لروّاد الأعمال، ومظاهر من البذخ المستفز، وغياب للذوق العام. ومع ذلك، تسهم هذه المادية في تغذية روح تنافسية حيوية. الأمريكيون والصينيون براغماتيون بطبعهم؛ يحملون عقلية “أنجز المهمة”، وهي عقلية تدفع أحيانًا نحو القرارات المتسرعة. وكلا البلدين يعجّ بالمغامرين الذين يبحثون عن طرق مختصرة في الصحة والمال والنجاح.
كما تتقاطع ثقافة البلدين عند تقديرهما العميق لما يمكن تسميته “سحر التكنولوجيا” ذلك الشعور بالرهبة أمام المشاريع التي تتحدى حدود المادة والواقع. وفي حين تشعر النخب في البلدين بالقلق من آراء عامة الناس، إلا أن النخب والجماهير تتفق معًا على إيمان راسخ بتفوّق بلدانهم وقوتها الاستثنائية، وعلى ضرورة إظهار هذه القوة حين تتردد الدول الأصغر في الامتثال.
وقد تشكّل لديّ هذا الانطباع بوصفـي كنديًا قضيت سنوات من حياتي بين الولايات المتحدة والصين. بالنسبة لي، هذان البلدان مثيران، مربكان، وغريبان إلى حدٍّ عميق، فالقيادة في شوارع أمريكا أو الصين، تكشف لك عالمًا نابضًا بالحياة على حافة الجنون وهي فوضى ليست مذمّة تمامًا، بل الوجه الآخر لتأثير هذين البلدين بوصفهما محركين رئيسيين للتغيير العالمي. أما أوروبا فتبدو، في المقابل، متفائلة فقط تجاه ماضيها؛ عالقة في اقتصاد يشبه الضريح، تغذّيه قناعة بالتفوّق تجعلها مترددة في تبنّي الممارسات الأمريكية أو الصينية. أما بقية دول العالم، فهي في الغالب “ناضجة أكثر من اللازم” أو “فتية أكثر من اللازم” لتتمكن من مجاراة الزخم الذي تصنعه واشنطن وبكين. فهذان البلدان وادي السيليكون، شنتشن، وول ستريت، بكين هي البيئات التي تحدد ما سيشتريه الناس وما سيفكرون فيه في أنحاء العالم. وعلى الرغم من كل ما سبق لا بد من القول ليست الولايات المتحدة والصين وحدهما الدولتان المهمتان في النظام الدولي، لكن تجاهل كيفية عملهما وكيفية تفاعلهما يعني تفويت فهم جزء كبير من التحولات الكبرى في عصرنا. فكلتاهما تعيدان تشكيل العالم، وكلتاهما تؤثران في الأخرى. ورؤية الصين بوضوح بما تملكه من قوة هائلة وضعف عميق وتناقضات واسعة—تساعدنا أيضًا على رؤية أمريكا بوضوح أكبر.
عن بكين
لفهم الصين بعمق، لا بدّ من البدء من أكثر مدنها إثارة وتعقيدًا: بكين. فجاذبية هذه المدينة لا تنبع من جمالها لأنها في الواقع ليست جميلة بل من كونها مدينة تكشف حقيقة الصين كما هي، دون تجميل أو زخارف.
فالحياة في بكين قاسية وفق معظم المعايير. تقع المدينة في شمال الصين الجاف، حيث تهبّ بين الحين والآخر عواصف رملية تضرب الأزقة القديمة ذات الطابع الإمبراطوري، كما تضرب العمارات الخرسانية الرمادية المبنية على الطراز السوفييتي. وإذا رغبت في اختبار المخاطرة، فما عليك إلا محاولة عبور الطرق العملاقة التي تنطلق فيها السيارات بلا هوادة. تبدو شوارع بكين كما هو الحال في موسكو أو بيونغ يانغ وكأنها شُيّدت لاستعراض القوة العسكرية أكثر من كونها مصمّمة لخدمة احتياجات السكان اليومية. وبمعنى ما، يبدو أن كل خطأ ممكن في تصميم المدن قد وجد طريقه إلى بكين.
ومع ذلك، تبقى العاصمة مدينة ذات ثقل وجوهر لا يمكن إنكاره. فهي مركز جذب لألمع العقول في البلاد: علماء، مطوّرون تكنولوجيون، ومئات الطامحين إلى التقدّم داخل مؤسسات الدولة والحزب الشيوعي. أما أعضاء المكتب السياسي بملامحهم الصارمة، فهم لا يرون في “العظمة” شعارًا دعائيًا، بل مشروعًا وجوديًا يتعلق بالحياة والموت، بالنسبة للدولة وبالنسبة لهم.
زيارة الأماكن
عملت جاهدًا على فهم الاتجاه الذي يدفع فيه “شي جينبينغ” بالصين، وكان ذلك يتطلب قراءة النصوص الحزبية مهما بلغت تعقيدها، وزيارة مناطق متفرقة مهما بدت نائية أو هامشية. ومن خلال السفر المتكرر إلى مدن صغيرة — بعضها لم يكن أكثر من مجمعات صناعية تحوّلت لاحقًا إلى مدن كاملة أدركت حقيقة لا يعرفها كثير من الأمريكيين، وربما حتى كثير من الصينيين أنفسهم: زيارة المدن المجهولة في الصين تجربة ممتعة بالفعل.
ففي كل مكان ذهبت إليه، وجدت طعامًا مذهلًا، ومناظر غير مألوفة، وأناسًا يصعب نسيانهم. ولمست أن للصين ديناميكية وحيوية لا تعكسها العناوين الإخبارية المختزلة التي تركز على ألاعيب السياسة في بكين. تخيّل فقط حجم الخطأ لو حاول أحدهم فهم الولايات المتحدة من خلال ما يحدث في واشنطن العاصمة وحدها. في كل رحلاتي لمست إيقاع الصين المتسارع بل المتهور أحيانًا. ولقد حاولت توثيق تحولات البلاد وصراعاتها، خاصة في ظل الجائحة وتدهور البيئة الدولية، عبر كتابة رسالة سنوية تمثّل بمثابة مذكرات شخصية لما أراه وأعيشه :
• في عام 2020 كتبت عن قراءتي لجميع خطب شي جينبينغ المنشورة في مجلة الحزب النظرية “البحث عن الحقيقة ».
• وفي عام 2021 تناولت الفروق العميقة بين هونغ كونغ وبكين وشنغهاي.
• وفي عام 2022 كتبت عن تجوالي بين جبال مقاطعة يونّان في ذروة سياسة «صفر كوفيد»، حيث يجاور شمالها التبت التاريخية، بينما يحمل جنوبها طابعًا أقرب إلى تايلاند.
ورغم انغماسي الكامل في تفاصيل الصين، كانت الولايات المتحدة حاضرة دائمًا في ذهني. فالأمر لم يكن مجرد حرب تجارية وتكنولوجية أطلقتها إدارة ترامب، بل لأن بكين تراقب الولايات المتحدة بتركيز دائم. فالقادة الصينيون مستعدون لتعلّم الكثير من أوروبا واليابان وسنغافورة، نعم، لكنهم ينظرون إلى الولايات المتحدة بوصفها النموذج الأعلى، ويقيسون أنفسهم دائمًا على المعيار الذي ترسيه القوة العظمى الأولى في العالم. ولفترة طويلة، كانت الولايات المتحدة والصين مكملتين لبعضهما البعض بصورة لافتة. لم يكن من المصادفة أن البلدين بنيا، على مدى عقود، شراكة اقتصادية أفادت المستهلكين الأمريكيين والعمال الصينيين في آن واحد. لكن على المستوى السياسي، يشكل النظامان نموذجين متناقضين جذريًا: فالولايات المتحدة تجسد فضائل التعددية وحماية الأفراد، بينما تعرض الصين مزايا ومخاطر التحرك السريع لتحقيق تحسينات مادية واسعة النطاق. وخلال العقود الأربعة الماضية، أصبحت الصين أكثر ثراءً، وأكثر تقدمًا تكنولوجيًا، وأكثر جرأة دبلوماسية. لقد تعلمت بكين الكثير من الولايات المتحدة، إلى درجة أنها بدأت تنافسها، بل وتتفوّق عليها في لعبتها المفضلة: الرأسمالية، التصنيع، وتسخير الطموح الشعبي الجامح.
وبينما كانت الصين تقلد نجاحات أمريكا السابقة، انشغلت الولايات المتحدة بتقويض بعض نقاط قوتها الجوهرية. فالنزعة الإجرائية لدى اليسار تداخلت مع النزعة الهدامة لدى اليمين لتقويض قدرة الدولة على العمل. ولم يسمح أيٌّ من الجانبين للحكومة بأداء الخدمات الأساسية المتوقعة. وحتى عندما مررت إدارة بايدن تشريعات تاريخية في السياسة الصناعية، تورطت الوكالات التنفيذية في تفاصيل إجرائية عطّلت التنفيذ الفعلي، قبل أن يعود الناخبون، ويعيدوا انتخاب دونالد ترامب الذي هدد بإلغاء معظم تلك البرامج. عموما يُمكن القول لا تزال الولايات المتحدة قوة عظمى قادرة على التفوق على الصين في كثير من المجالات، لكنها كذلك أسيرة دولة تعاني عجزاً مؤسساتياً، وشعب بات منشغلًا أكثر بالحفاظ على مستوى معيشته المريح.
معلومات كثيرة وردت في الكتاب، وهي بالفعل تستحق النقاش والاطلاع، ومع ذلك قد يحمل قارئ الكتاب كثيراً من التحفظات حول بعض الأفكار الواردة فيه، إلا أنّ أهمية هذا النوع من الكتب تكمن في محاولات الفهم، في عالم يحكمه الحكم المسبق.